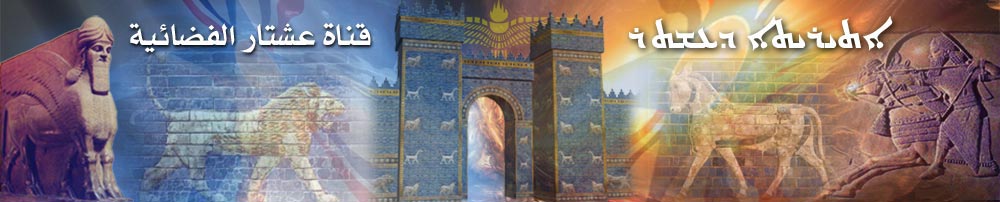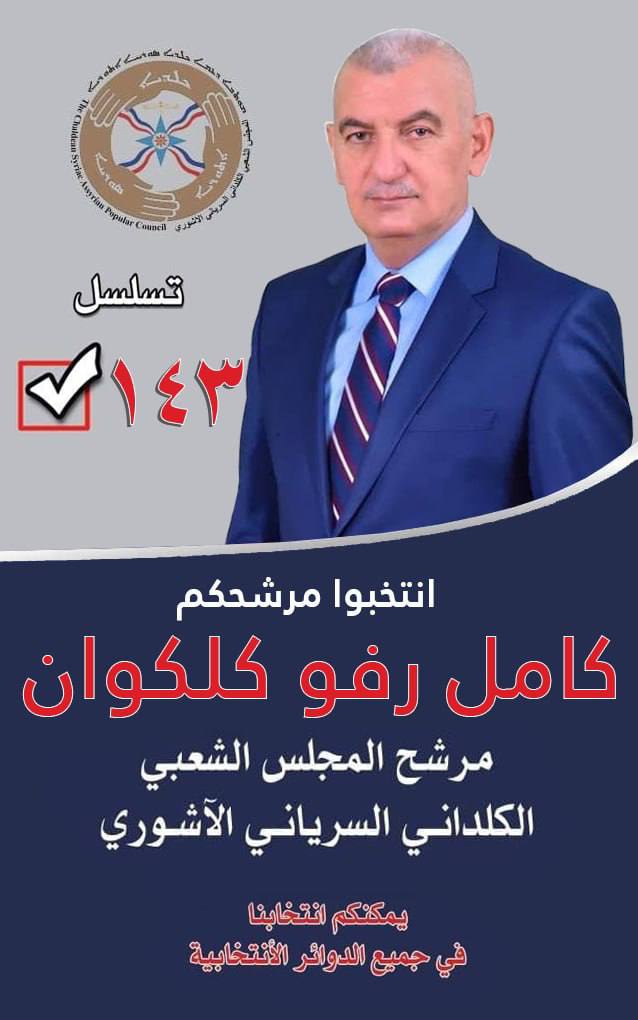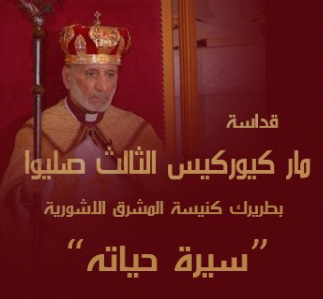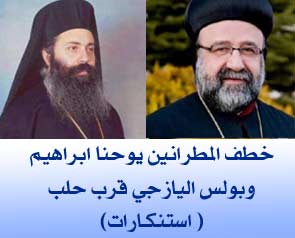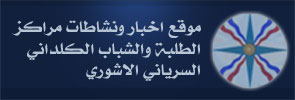قراءة في ( سفر بندورة)
نشوان عزيز عمانوئيل
هذه قراءة نقدية لمجموعة قصصية صدرت قبل سنوات للقاص الدكتور ناظم علاوي، ورغم تقادم زمن صدورها، فإنها ما زالت تحتفظ بقدرتها على إثارة الاهتمام، وتبقى عملًا مهمًا وجديرًا بالقراءة والتأمل في سياق القصة القصيرة العربية.
مقدمة :
تأتي مجموعة سفر بندورة للأديب ناظم علاوي ضمن سياق السرد العربي المعاصر الذي يسعى إلى إعادة تعريف القصة القصيرة باعتبارها مساحة مفتوحة للتجريب اللغوي والبنائي، وفي الوقت نفسه إطارًا حاملاً لتجربة إنسانية ذات أبعاد متعددة. النصوص الواردة في هذه المجموعة تنطلق من بيئة واقعية ذات ملامح اجتماعية وتاريخية واضحة، غير أنها لا تكتفي بالتوثيق المباشر، بل تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع عبر آليات التخييل، ما يمنحها بعدًا فنيًا يتجاوز الإطار التقريري.
تتسم المجموعة بتنوع موضوعاتها، رغمَ حضور ثنائية الفقد والبحث، سواء على المستوى الشخصي أو الجمعي، وفي توظيف المكان والزمان كمكوّنين فاعلين في بناء الدلالة. كما أن البنية السردية تميل في كثير من النصوص إلى كسر الخطية التقليدية، لصالح تداخل الأزمنة وتعدد وجهات النظر، مما يتيح للقارئ مقاربة النصوص من زوايا متعددة، فهي تعتمد النصوص على معجم يتراوح بين البساطة المباشرة والتكثيف الشعري، وتستثمر الصور الرمزية والمجازية بشكل يوازن بين وضوح الفكرة وثراء التعبير. ويتجلى في ذلك وعي الكاتب بأهمية الإيقاع الداخلي للنص، حيث تتكامل الجملة السردية مع النبرة العامة للنصوص لتشكيل مناخ سردي متماسك.
في قصة "سفر بندورة"، يختار الكاتب بداية ميتاسردية:
"كنتُ أجلس على طاولة المقهى، أنظر إلى الورقة البيضاء، وأفكر أن كل ما سأكتبه لن يشبه ما كان." هذه الافتتاحية تشبه إشهارًا مبكرًا بفشل الكتابة في اللحاق بالحياة، لكنها أيضًا تخلق فضولًا عن "ما كان"، أي ذلك الماضي الذي سيحاول السرد استعادته عبر المداخل المتعددة. اللافت أن هذا الاعتراف يربط القارئ منذ البداية بعقلية راوٍ يدرك استحالة المطابقة بين التجربة ونصّها، وهو ما يمنح النص بعدًا تأمليًا مبكرًا.
أما في "طقوس خاصة"، فإن البداية تكشف المسار النفسي للنص من أول كلمة: "أغلق الباب، وأخلع قميصي، كأنني أخلع عني يومًا كاملًا." هنا، الفعل الحسي المألوف يُضخّم بإسناد مجازي، ليصبح خلع القميص معادلاً لخلع ثقل اليوم، مما يوحي بمناخ من العزلة والانكفاء سيستمر في تشكيل النص حتى نهايته.
في "الأخرس"، يضع الكاتب المفارقة المركزية أمام القارئ مباشرة: "لم يعرف صوته يومًا، ومع ذلك كان يعرف أن له قلبًا." هذه الجملة الأولى تبني الشخصية على نقيض جوهري: الغياب الجسيم (الصوت) مقابل الحضور المؤكد (القلب)، وكأنها تقول إن الإحساس أحيانًا يسبق القدرة على التعبير عنه. هذا التناقض سيبقى المحرك العاطفي للقصة حتى لحظة الخاتمة الصامتة.
"حليب الوجع" تفتتح بجملة تستدعي السفر والتنقل لكنها تنقلب سريعًا إلى رحلة داخلية: "جلس في القطار يحدّق من النافذة، لكن ما يراه كان يأتي من الداخل." هذه البداية تحسم من اللحظة الأولى أن المشهد الخارجي ليس أكثر من محفز للتقليب في الذاكرة أو الغوص في الهذيان، ما يجعل القصة بأكملها رحلة ذهنية قبل أن تكون تنقّلًا جغرافيًا.
في "عصطاف"، تأتي البداية كجزء مبتور من محادثة مع العالم: "قلت لها إن الليل لا يكتمل إلا بعينيها، فضحكت كمن يعرف النهاية." الجملة تبني مناخ الحكاية على وعد رومانسي معلّق يواجه وعيًا مبكرًا بالنهاية، وكأن القصة كلها ستظل محكومة بهذه المفارقة بين البدايات التي توحي بالأبدية والنهايات التي تسبق نفسها.
أما "أعنيك لهذا"، فإنها تبدأ بجملة أقرب إلى ومضة اعتراف: "كتبت اسمك على الورقة الأخيرة، لأن البداية لم تعد تليق بنا." هنا، ينعكس الزمن السردي منذ الافتتاح: البداية تأتي في صورة نهاية، والنص يسير للخلف كما لو كان يتتبع أثرًا يتلاشى.
"سر شهريار" تفتتح على نحو يخلط التراث بالمعاصرة: "كان شهريار هذا العصر يجلس على مقعد بلاستيكي، يطارد دخان سيجارته." بداية تُسقط شخصية أسطورية في مشهد يومي شديد العادية، لتعلن منذ البداية أن النص سيتعامل مع الرموز التراثية لا كمقدسات، بل كمواد قابلة لإعادة التشكيل في سياق معاصر.
حتى النصوص القصيرة جدًا تمتلك افتتاحيات قوية. "للحب طعم الاحتراق" تبدأ بعبارة نارية: "قبّلتها، فاشتعل الليل." الاقتصاد اللغوي هنا يخدم الكثافة الشعورية، بحيث تختزل الجملة الأولى التجربة كلها. "شاطئ وإسفلت" تفتتح بمفارقة مكانية: "بين الشاطئ والإسفلت، ضاع ظلي."، ما يمنح النص من البداية إحساسًا بالتيه بين عالمين.
في جميع هذه الافتتاحيات، يثبت ناظم علاوي وعيه بأهمية الجملة الأولى كأداة لالتقاط القارئ لا بالحدث وحده، بل بالنبرة والمزاج العام. افتتاحياته ليست شروحًا لما سيأتي، بل شفرات تتضمن روح النص وتطلقها منذ اللحظة الأولى، بحيث يصبح الدخول إلى القصة أشبه بالقفز مباشرة إلى قلبها، لا التمهيد التدريجي لها.
وهنا سأعرج بشيء من التفصيل على أغلب سرديات المجموعة.
في "سفر بندورة"، يفتتح الكاتب باعتراف مربك:
> "كنتُ أجلس على طاولة المقهى، أنظر إلى الورقة البيضاء، وأفكر أن كل ما سأكتبه لن يشبه ما كان."
الورقة البيضاء هنا ليست رمزًا للعجز الإبداعي فحسب، بل هي أيضًا مرآة الذاكرة: مهما كُتب، سيظل ناقصًا أمام ما عاشه الراوي في الجبهة، على جبل بندورة. من اللحظة الأولى، يوظف النص الميتاسرد (السرد عن فعل السرد) ليدخل القارئ في لعبة مزدوجة: الحكاية عن الماضي، والحكاية عن استحالة الحكاية.
أما "طقوس خاصة" فتبدأ على نحو داخلي، بعبارة أقرب إلى منولوج نفسي:
> "أغلق الباب، وأخلع قميصي، كأنني أخلع عني يومًا كاملًا."
البدء بفعل إغلاق الباب يضع القارئ مباشرة داخل عالم العزلة والانكفاء على الذات. خلع القميص ليس فقط فعلًا جسديًا، بل هو أيضًا استعارة لتعرية الروح، تمهيدًا لطقوس الوحدة التي سيكشف عنها النص لاحقًا.
وفي "الأخرس"، تأتي البداية كضربة صمت:
> "لم يعرف صوته يومًا، ومع ذلك كان يعرف أن له قلبًا."
هنا، يضعنا الكاتب أمام المفارقة المركزية للقصة منذ جملتها الأولى: الفقد المزدوج للصوت والكلام، مقابل حضور القلب والإحساس. الافتتاحية تختزل مسار النص كله، حيث تتصاعد مأساة العجز عن النطق في مواجهة اللحظة التي كان من الممكن أن تغيّر حياة البطل.
حتى النصوص القصيرة جدًا في المجموعة تملك بدايات تحمل كثافة مماثلة. في "للحب طعم الاحتراق"، تبدأ القصة بجملة مباشرة:
> "قبّلتها، فاشتعل الليل."
وهي جملة ليست بحاجة إلى تفسير طويل؛ فهي تقدم المشهد العاطفي كحدث كوني، يشتعل فيه الليل نفسه، كأن الحب نار قابلة لابتلاع الظلام. الجملة تعمل كقصيدة قصيرة تختزل القصة كلها.
سفر بندورة ليست مجرد مجموعة قصصية، بل هي أشبه بمرآة مكسورة، كل شظية منها تعكس وجهًا من وجوه الكاتب ووجوهنا نحن، نحن القراء الذين نحمل حروبنا الصغيرة والكبيرة. النصوص هنا لا تطلب من القارئ أن يصدقها، بل أن يعبرها، أن يتوه فيها قليلًا، أن يختبر المسافة بين الحلم حين يولد والحلم حين يُدفن.
ناظم علاوي يكتب كمن يضع يده على جرح قديم لا يندمل، ليس ليوقف النزيف، بل ليتأكد أنه ما زال حيًا. لغته تشبه قاربًا على نهر واسع: تميل أحيانًا مع التيار، وتقاومه أحيانًا أخرى، لكنها لا تتوقف. وبين كل قصة وأخرى، بين جبل بندورة ونهر دجلة، بين مقهى الموصل وقطار بغداد، يظل القلب البشري هو ميدان المعركة الحقيقية، حيث الحب والحرب وجهان لعملة واحدة، وحيث الكتابة ليست خلاصًا، لكنها على الأقل تمنع النسيان من أن يربح الحرب الأخيرة.
إن القيمة الأدبية للمجموعة لا تكمن فقط في موضوعاتها أو في شحنة التجربة التي تحملها، بل في طريقة صياغتها، حيث تتضافر اللغة والصورة والبنية لتقديم نصوص تشكل مجتمعة لوحة فسيفسائية لوعي معاصر، ولفعل الكتابة ذاته كوسيلة لمقاومة النسيان واستبقاء المعنى في وجه الفقد. وبهذا، تمثل سفر بندورة نموذجًا يُحتذى في كيفية استثمار القصة القصيرة كفن مفتوح على إمكانات التجريب والابتكار، دون التفريط في المضمون الإنساني العميق.
سفر بندورة ليست مجموعة قصصية فحسب، بل دفتر ذاكرة مفتوح على الريح. نصوصها تمضي بين رائحة البارود وظلّ المقاهي، بين صمت الجبهات ووشوشة النساء، لتجمع الحلم بالخذلان في قبضة واحدة. هنا، الحرب ليست خلفية، بل كائن يتنفس في كل سطر، والمدينة ليست مكانًا ثابتًا، بل ممرًّا عابرًا للذكريات.
لغة ناظم علاوي تمشي على حافة النثر والشعر، تلتقط اللمحة العابرة كما تلتقط المشهد المكتمل، وتعيد رسم الوجوه التي عبرت الحياة ثم غابت. القصص، مهما اختلفت، تتآزر لتكوّن فسيفساء واحدة عن إنسان يكتب كي يمنع النسيان من الانتصار الأخير. إنها شهادة أدبية على زمن مثقل بالرحيل، وموسيقى خافتة تصاحب القارئ حتى بعد أن يغلق الكتاب.
ومن أقوى ما يميز هذه المجموعة هو افتتاحيات النصوص التي غالبًا ما تأتي محملة بطاقة شعرية وكثافة رمزية قادرة على شدّ القارئ منذ الجملة الأولى. الكاتب يجيد توظيف المفارقة والاستعارة، ويعرف كيف يضع صورة واحدة تكفي لتلخيص مناخ الحكاية.
قوة أخرى لافتة تكمن في البنية غير الخطية للسرد، حيث يميل النص إلى الدائرية أو القفز بين الأزمنة، ما يعكس طبيعة الذاكرة البشرية ويمنح النصوص بعدًا تأمليًا. كما أن الحس البصري في الوصف حاضر بقوة؛ الأماكن ليست مجرد خلفية بل تتحول أحيانًا إلى شخصيات قائمة بذاتها، سواء كان المكان جبلًا أو مقهى أو عربة قطار.
اللغة في معظم القصص تمتلك مستوى تعبيريًا عاليًا، يمزج بين السرد النثري والشعرية، مما يخلق إيقاعًا داخليًا ينسجم مع موضوعات النصوص. كذلك، هناك قدرة على دمج الذاتي بالجمعي، بحيث لا تنعزل التجربة الفردية عن سياقها التاريخي والاجتماعي، وهو أمر يزيد من عمق الأثر.
في المحصلة ومن وجهة نظر شخصية تبقى سفر بندورة عملًا متماسك الروح، يمتلك بصمة أسلوبية خاصة، ويقدّم نفسه كجسر بين القصة القصيرة الكلاسيكية والنص المفتوح على الشعر والتأمل. إنها مجموعة تعرف كيف تُدخل القارئ في لحظة وتتركه هناك، لا لغياب الخاتمة، بل لأن الخاتمة، مثل الحياة، تظل مفتوحة على احتمالات لا تنتهي.
نشوان عزيز عمانوئيل
ستوكهولم

- 2025-08-20 المتحدث باسم وزارة البيشمركة: خلال الشهرين القادمين ستُصرف رواتب البيشمركة عن طريق حسابي
- 2025-08-20 مجلس أعيان الصابئة المندائيين: أكثر من 50 عائلة صابئية غادرت العراق خلال الأشهر الخمسة الأخيرة
- 2025-08-20 دمار وترقب.. وزير دفاع إسرائيل صادق على خطة احتلال غزة
- 2025-08-19 عاصمة نوروز تدخل مرحلة جديدة في عالم السياحة
- 2025-08-19 أنصار الله الأوفياء: إسرائيل ستهاجم الفصائل المسلحة في العراق
- 2025-08-19 10 أيام لبحثها.. 4 ضمانات أمنية مقترحة حول كييف
- 2025-08-18 حكومة إقليم كوردستان تنفذ 564 مشروعاً استثمارياً بأكثر من 24 مليار دولار
- 2025-08-18 واشنطن وبغداد تعلنان تحول مهام التحالف الدولي في العراق إلى "شراكة أمنية ثنائية"
- 2025-08-18 خطة الإصلاح المصرفي في العراق تثير خلافات بين البنوك الخاصة والبنك المركزي
- 2025-08-18 ترمب يستبعد استرجاع أوكرانيا للقرم: لا عودة للخلف.. وبإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب الآن
- 2025-08-17 أمريكا تسحب كامل قواتها من بغداد إلى أربيل
- 2025-08-17 فؤاد حسين: نجحنا في إبعاد العراق عن ساحة الحرب ونزع السلاح من الفصائل يحتاج لحوار
- 2025-08-17 إسرائيل توسع بحثها عن وطن لفلسطينيي غزة
- 2025-08-16 الحكومة العراقية تمضي بمشروع استيراد الغاز المسال لتأمين الكهرباء
- 2025-08-16 الأهوار مهددة بالزوال.. تقرير دولي يدق ناقوس الخطر في العراق
- 2025-08-16 مخرجات قمة ترامب وبوتين.. لا اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا
- 2025-08-15 اتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على بدء أعمال البرلمان في سبتمبر أيلول
- 2025-08-15 تركيا ترد على دعوة لمنع شركاتها من العمل في العراق: لم نخفض الاطلاقات المائية
- 2025-08-15 ترامب وبوتين.. تقرير يتحدث عن 4 نتائج محتملة لقمة ألاسكا
- 2025-08-14 أربيل تدخل مرحلة تنموية جديدة بمشاريع استراتيجية في المياه والكهرباء والطرق
- المزيد
- 2025-08-20 محللة أبحاث تحذر: "لن تكون أي مؤسسة دينية مستقلة في مأمن" إذا استولت الحكومة المصرية على دير سانت كاترين
- 2025-08-20 ساستُنا في حكومات المحاصصة: الحكمة أن تعرفوا قدرَ أنفسكم
- 2025-08-20 الحنين إلى الماضي.. مفتاح صداقات تدوم مدى الحياة
- 2025-08-20 لا ليغا.. مبابي يهدي الفوز لريال مدريد "المتواضع"
- 2025-08-20 قداسة البطريرك مار آوا الثالث، يزورصاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، و نيافة المطران مار اقليمس دانيال كورية
- 2025-08-20 محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، برفقة السفير النمساوي لدى العراق أندريا ناسي، يزوران كنيسة مسكنتة أقدم كنائس المسيحيين في الموصل
- 2025-08-20 النائب الأسترالي أندرو برادوك يدعو للاعتراف بمجازر سيفو 1915: “في ظل الصمت، تجدُ الإبادة صديقاً لها”
- 2025-08-20 البطريرك الراعي: لبنان هو وطن نهائي لكل لبناني، وهذا يتطلّب الولاء من جميع أبنائه
- 2025-08-20 مبادرة الأب كايلي… دعم مسيحيّي الشرق بالصلاة وفرص العمل
- 2025-08-20 المتحدث باسم وزارة البيشمركة: خلال الشهرين القادمين ستُصرف رواتب البيشمركة عن طريق حسابي